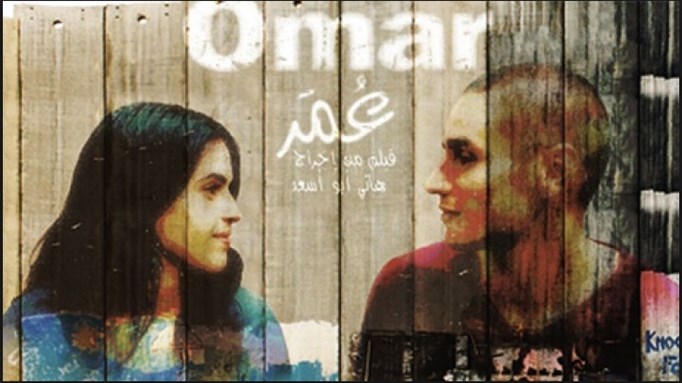ترى كم تاريخٍاً للثقافة في العراق "وهل العراق بدع من البلدان ليكون له تواريخ ثقافية عديدة!؟" شخصياً لا أدري؛ مادام أن للثقافة تاريخياً شخصياً: تاريخ أفراد بعينهم، كثيرون يعضون على نواجذهم قائلين، لأنفسهم ربما، أن الثقافة شان ذاتي، بول ريكور، مثلاً، يشدد في مدونته الكبرى، أن الذاكرة شان السرد، إنما تتعلق بذات تتكلم وتتذكر وتحكي، لكنه لم يقل مطلقاً: اننا أمام طوفان من التواريخ، لكني أرى، للأسف، ان الثقافة ربما تكون سجلاً ضخماً يشكل، بمجموعه، طوفاناً من التواريخ الشخصية للمثقفين في العراق. أتصور أننا، هنا، إزاء سيل عارم من الأمزجة والمصائر الشخصية التي تدعي، بحق أو سواه، أنها بصدد إنتاج الثقافة في بلادنا.
السنوات السالفة، بدء من 9، 4 تكشف عن ترسخ هكذا توجه؛ فاغلب ما صدر من شهادات بمقالات، أو بكتب، أرخت، بل تابعت، بإصرار ودأب دور كاتبها في مجمل التاريخ الثقافي للبلاد، وقد نقول إنها قد وضعت تاريخها الشخصي في مكانة أعلى بكثير من التاريخ الثقافي العام. مثل هكذا أمر نجده، للأمانة، بصيغته المبكرة في المساجلة التاريخية بين اثنين من أبرز شعراء الستينيات، "فاضل العزاوي" و"سامي مهدي" عبر كتابيهما "الموجة الصاخبة" و"الروح الحية". تلك المساجلة لا تخفي، مطلقاً، التاريخ الشخصي لأصحابها، وإن تقنعت بصراع سياسي – ثقافي.
ولنا أن نتذكر الجملة، أو العبارة اللافتة التي ختم بها "سامي مهدي" مقدمة كتابه تعقيباً على كلام محرر كتاب "انفرادات الشعر العراقي الجديد" الشاعر "عبد القادر الجنابي"، بقوله "وبعد فإن للمرء أن يتساءل: إذا كان هؤلاء السادة على هذه الدرجة من الاستعداد للحقد والكذب وتشويه الحقائق وهم بلا سلطة ونفوذ، فكيف كان الأمر سيكون لو كانت لهم سلطة ونفوذ؟". وفي المحصلة إنما ذهبت الأحزاب وشعاراتها إلى حتفها، ولم يبق سوى الألم، الأحرى، ربما، أن نقول التألم الفردي لحياة بددت عبثاً وهراءً. ولا باس ففي النهاية كان على شاعر من طراز "سامي مهدي" أن يقرر ما عليه، أن يجلس وحيداً إلى نفسه، ولاحقا، ربما، يكتب شعره ومقالاته، بل وكتبه، مثلما كان على غيره أن يحزم حقائبه "هل كان لكثيرين منهم حقائب، أشك؟!" ويغادر البلاد، لنتذكر "سعدي يوسف" مثلاً، الذي سمعت أن "سامي" قد علق يوماً عليه "الآن تعادلنا!" كما لو أننا في إحدى الصياغات الكبرى لهوليود التي جمعت في فيلم رئيس بين "أنطوني كوين" و"أولفر ريد"، وكان لهما، على طريقة الكاوبوي الأمريكي، أن يتصارعا، بعد حين قال أحدهما للآخر: لنقل إننا تعادلنا. هكذا، إذن.. تنتهي الأمور عندنا ب"الكاوبوي"، وليس بغيره! مثلما أن أحدكم، أو كلكم، يسال نفسه الآن ما علاقة "الأقلام" المجلة العراقية، بل العربية الرئيسة المعنية بالأدب العربي الحديث مثلما تذكر افتتاحية مجلة "فصول" القاهرية، وهي الأبرز عربياً، على الأقل في الثمانينيات، عندما كتبت في عددها الأول، بحثاً عن هوية مفترضة للمجلة الجديدة بصيغة سؤال رئيس: كيف تكون مجلة "فصول": أهي صورة عن الأقلام العراقية مثلاً؟ نعم، ما علاقة مجلة الأقلام بالتاريخ الشخصي، والذاتي، بل المغرق بالشخصانية للمثقف العراقي؟
أتصور أنه ما من مجلة عراقية رئيسة عبرت بإخلاص نادر عن ارتباطها بالمؤسسة الرسمية، بل عن التوجهات السياسية للأنظمة السياسية المتعاقبة على حكم البلاد، وبالأخص نظام البعث كما فعلت مجلة الأقلام؟ نحن هنا إزاء تاريخ شنيع من التباعد، بل الإنكار لأي طابع فردي، ذاتي يمكن أن نلمسه في نص بعينه، حتى النصوص الشعرية التي من المفروض أن تستجلي ذواتاً تتعامل مع واقع عراقي ملتهب، كانت تُختار بعناية فائقة لتعبر عن التوجهات السياسية لنظام الحكم، لا نتحدث، بالضرورة عن البعث وتوجهاته، إنما الحديث يخصه بحكم طول فترة حكمه. لنعد لأول الحكاية، السنوات الأولى لإطلاق مجلة الأقلام، صدر عددها الأول في شهر أيلول سنة 1964. أمامي الآن مجموعة من أعدادها الأولى، عشرة أعداد ويزيد، كتب على غلافها الداخلي عبارة موجهة تقول: مجلة فكرية عامة تصدرها وزارة الثقافة والإرشاد، هي، إذن.. لم تكن مجلة أدبية، أو معنية بشؤون الدراسات الأدبية مثلما كان الأمر في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، وقد عادت الآن إلى لحظتها الأولى: مجلة فكرية عامة، وهي، كذلك، مجلة تصدرها وزارة الثقافة، فهي مجلة حكومية ولم نسمع يوماً أن الحكومة ممثلة بوزارة الثقافة قد تخلت عنها، أو تركتها لأهواء الناشرين "نكتة سمجة ان نتحدث عن الناشرين غير الحكوميين في العراق!".
من يتصفح البحوث المنشورة في تلك الأعداد يصاب بصدمة، ولا أظنه سيخرج بحصيلة من ذلك التصفح سوى بسؤال مشبع بتعجب مرير: أحقاً نشرت الأقلام تلك البحوث؟ ولا ادري لماذا فكرت أن مكانها، اقصد تلك البحوث، هو مجلة مختصة بمعهد المخطوطات أو ما شاكله! بحوث ليس فيها سوى الطابع السائب لنظام سياسي لا يعرف ماذا يريد، خلطة غريبة من أفكار قومية إسلامية، وهو شان تلك البحوث والقصائد المنشورة، آنذاك، على قلتها. بالطبع ليس هناك أي ذكر للأدب العربي الحديث، العراقي منه بوجه خاص كما لو أن هذا الأدب، شعراً بصورة مخصوصة، قد ألغي من ثقافة البلاد، وللمفارقة ان سنة صدور المجلة صادفت وفاة أبرز شعراء القصيدة الحديثة في العراق، وهو السياب! لماذا حدث هذا الأمر؟ لا أدري! المؤكد لدي أن النظام كان يبحث عن مجلة تعبر عنه، وكانت الأقلام، لسوء حظها، هي تلك المجلة. بعد حين سيجد مثقفو البعث صيغة أخرى لتخليص الأقلام من هراء السياسة وكتابها الإيديولوجيين، فاخترعوا مجلة جديدة، كان لها أن تأخذ صيغة النظام السياسي بأكمله، هي مجلة "آفاق عربية"، ولا ادري من من كبار مثقفي البعث وراء اقتراح "آفاق عربية"؛ فهي لم تكن محض مجلة، انما مؤسسة ثقافية كاملة، تولت مهمة التعبير عن أيديولوجيا النظام وتوجهاته السياسية، وليس غريباً، من ثم، أن البغداديين لا يعرف اسماً آخر لدار الشؤون الثقافية غير "آفاق عربية"!
هكذا، تخلصت الأقلام مما ظل عالقاً بها، وتفرغت للأدب العربي الحديث، وحتماً كان لصدور مجلة عراقية بارزة أخرى، هي المورد "صدر عددها الأول عام 1972"، أثر فاعل في ترحيل البحث التراثي وما يتعلق بالأدب العربي القديم إلى المجلة الجديدة. أصبح لدينا الآن مجلة مختصة بالأدب العربي الحديث، ولقد عزز هذا التوجه بإسناد المجلة إلى أحد أقطاب الرواية والقصة، انه الكاتب الروائي "عبد الرحمن مجيد الربيعي" الذي نهض بها كثيراً، وأعاد صياغة هويتها كمجلة معنية، بل ومختصة بشؤون الأدب الحديث. لكنه، أي "الربيعي" فشل في إبعادها عن التوجهات الثقافية للنظام السياسي الحاكم. ولا أدري إن كان "الربيعي" قد فكر، بالفعل، بهذا الأمر، لنتذكر أن "الربيعي" نفسه هو مخترع ما عرف، لاحقاً، ب"الرواية القومية"!؟ لأجله، ربما، نجد الأقلام قد سارت على نهج لم تخرج عنها، يمكن تسميه سريعاً بالنهج الثقافي الأدبي لنظام الحكم، فقد كانت المجلة مغلقة على كتاب بعينهم، عرب وعراقيين، وقد أتحدث عن إحصائية سريعة لأسماء بعينها كانت المجلة ملتزمة بالنشر لهم، في المقابل جرى حرمان اغلب الكتاب الشاب، ومن هم سابقون عليهم ممن لا يتفقون مع النظام، أو ممن لدى النظام ملاحظات على ما ينشرون خارج المجلة.
وربما يقال إن المجلة كانت مختصة بالنشر للكاتب المكرسين والمشهورين، ثم أن وزارة الثقافة قد أصدرت مجلة مختصة بنشر أدب الشباب، هي الطليعة الأدبية. وهي وقائع مشبعة بالمغالطات؛ فان أديباً مكرسا كـ"جمعة اللامي"، مثلاً، ظل بعيداً عن النشر في "الأقلام" ومثله العشرات. ترانا، فيما نكتب الآن، نبتعد عن فرضية التاريخ الذاتي للمثقف في سياق قراءة تاريخ "الأقلام"، أبداً، نحن في سياق يرى أن "المجلة" كانت تعبر عن السياق الثقافي لنظام الحكم، بل إنها أخذت على عاتقها مهمة تقديم هذا النظام عربياً، ومن يقرا أعدادها في سبعينيات القرن الماضي يجد احتفاءً لافتاً بالأسماء الأدبية المتمردة عربياً، بل والممنوعة هناك، وليس غريباً، بعدها، أن تسمح إدارتها بنشر نصوص طليعية مشبعة بالتمرد، في المقابل كان هناك شحة واضحة في النصوص العراقية الرائدة والمؤسسة مما سمح له بالظهور في أعداها. لكن المجلة كان لها شأن آخر في الثمانينيات عندما أسندت رئاسة تحريرها إلى شاعر شاب وأكاديمي حصل على شهادته من "لندن" يعرف لغة أجنبية خلاف سلفه "الربيعي"، هو "علي جعفر العلاق". وبإمكان المتابع أن يلاحظ أن المجلة، في عهده، أخذت بالتخصص المعرفي بشؤون النقد بان اتخذت سياسية فتح المحاور الأدبية – النقدية المختصة طبعاً بالأدب والنقد العربي.
ومع ذلك، فقد ورطت المجلة بملفات أدبية سياسية عن أدب المعركة وما اقترب منه: أدبياً وثقافياً. غير أن الورطة الأهم كانت في تكريس وجهة نظر أدبية بالغة التعسف عن الأدب المطلوب، أو بكلمة أدق عن "الأدبية" المعترفة بها لتنشر نصوصها في المجلة الأدبية الرئيسة في العراق، وهي "الأقلام". أتحدث عن نصوص شعرية وقصصية نشرت في الثمانينيات لكتاب عرب وعراقيين، سمتها العامة انغلاقها على نفسها، ثمة معنى عائم، بعيد، وقد نقول ملتبس، نصوص لا تقول شيئاً، تماماً مثل حربنا "المجيدة" التي طالت سنة بعد أخرى لتفقد العراقي كامل رغبته بالحياة، هل كانت تلك النصوص تعبير عن حرب بدأت بالصدفة وانتهت بالصدفة كذلك؟ ربما. أتصور أن تلك النصوص كانت، بجوهرها، نصوص حرب، وإن لم يجر التعامل معها بهذه الصفة. وأياً كان الأمر، فان المجلة حافظت على نسقها الرئيس، إنها مجلة النصوص المعتبرة والمعبرة عن توجهات المرحلة، مرحلة الصمت وموت المعنى، بل موت الذات المعبرة، وهل كان هناك من مطلب آخر غير أن يصمت الجميع! هذا الصمت اتخذ شكلاً جديداً في التسعينيات مع الإدارة الجديدة لأحد إيديولوجي النظام، إنه "ماجد السامرائي"، لكنه صمت فرضه، هذه المرة، الحصار الاقتصادي الذي أجبر الجميع على إتباع خطواته؛ فقد تقلص كل شي: حجم المجلة، فأصبحت شاحبة مقتضبة، واكتفت بنشر النصوص القصيرة المعبرة عن فكرة الاقتصاد ألقولي والحرفي بانفتاح يسجل على صعيد نوعية النصوص، فقد أصبحنا إزاء نصوص، على قصرها، تحاول أن تقول أمراً، ثمة تراجع نسبي لخوف الكاتب فرضه هول تدمير المكان العراقي بعيد كارثة حرب الكويت، نعم إننا نجد رثاءً لمكان دمر ويدمر يومياً. وهي ظاهرة أدبية اشترك الجميع في صياغتها، داخلاً وخارجاً، كان هناك بكاء صامت على البلاد، ولست متأكداً إن كان النظام قد دفع الأدب بهذا الاتجاه، لكني أجزم أنه اتجاه عام اشترك فيه الجميع: مؤيدون ومعارضون، مقيمون ومنفيون.
كلهم كتبوا عن بلاد ذبحها البرابرة الوطنيون والمحتلون الأجانب. غير أن الملاحظ أن "الأقلام" قد أخذت شكلاً جديداً مع تحسن ظروف البلاد الاقتصادية بعيد عام 1995 من دون أن تستعيد انتظام إصدارها الشهري، ومعها استعادة النصوص الموسعة مكانها ومثلها، بالضبط، سياسة المحاور الأدبي – النقدية. واللافت، حقاً، إن التسعينيات قد شهدت ضعف سطوة توجهات النظام السياسية عليها، فمن النادر أن نجد، في أعداد التسعينيات، ملفاً سياسياً بصيغة أدبية – ثقافية. والأكثر إثارة ان منتصف التسعينيات شهدت نشر نصوص تحاول أن تقول أمراً مختلفاً. والأهم أن المجلة قررت أخيراً أن تفتح بابها للأدباء الشباب القادمين، بالجملة، من المحافظات البعيدة، جنوباً أو شمالاً. وقد أزعم أن هذا التوجه فرضه هجرة أغلب أدباء السبعينيات والثمانينيات، شعراءً وكتاب قصة ورواية، وتركهم النشر فيها، طمعاً؛ ربما، بنشر نصوصهم في المنابر العربية. هذا الأمر أعطى المجلة زخماً مختلفاً أوقفه، للأسف، التغيير المفاجئ لإدارتها، لتستعيد، بعدها، نسقها كمجلة حكومية تعبر عن توجهات وزارة الثقافة والإعلام.
وهو ما بدا واضحاً في آخر عهدها قبيل إسقاط نظام البعث، أتحدث هنا عن الردود العنيفة ضد حوار أجراه الكاتب "ناطق خلوصي" مع الراحل الدكتور"عبد الاله احمد" عما أسماه الراحل في حواره بالـ"واقعية بلا ضفاف". ولا أعرف ما الذي استفز مهاجمي "الراحل" فيما قال؛ فلم يذكر الرجل أمراً جديداً خارج ما عرف عنه في الوسط الثقافي، إنما هي، بحسب ما أرى، عبارة "بلا ضفاف" التي رآها من كتب ضد الحوار خروجاً عن نسق النظام، بل اتهاماً للبلاد إنها قد أصبحت "بلا ضفاف"، وهو أمر ينكره إيديولوجيو النظام، ولاشك. كانت تلك الواقعة آخر صياغة سياسية للأقلام دخلت المجلة، بعدها، مرحلة التخبط بحثاً عن سياسة تتبعها في النشر، فقد ذهب مديروها بسقوط نظامهم السياسي، وكان عليها أن تواجه نفسها من جديد، فلمن تنشر، وما هي سمة النصوص، بل ما هي سمة النص "المعتبر" الذي تعتمده في النشر، والأهم من هو الذي يحدد هذه الأمور؟ ففي عهود البعث كان هناك من يفترض ويقترح ويفرض، في حين ترك هذا الأمر، بعد ذلك، للعشوائية، وقطعاً لثقافة وسياسة مدير التحرير. من يقرا أعداد المجلة حتى عام 2008 يلاحظ موتاً سريراً للمجلة، بل اننا أصبحنا نقرأ نصوصاً منشورة في الأقلام "الأقلام وليس غيرها!" لم تكن تجرأ جريدة شعبية غارقة بفضائحيتها كجريدة "الراصد" الثمانينية على نشرها؛ لضعفها وتفككها، ومثلها ما نشر من دراسات مال أغلبها للضعف وقلة الاعتبار.
ففي السنوات الخمس خسرت "الأقلام" ما حافظت عليه لأكثر من أربعين عاماً، ذلك بانها لم تعد معياراً للنصوص المعتبرة عندما كان النشر بالأقلام يعني ببساطة إنك قد أصبحت كاتباً. وهي خسارة كبرى لم يدرك المسؤولون عليها حجم ضررها حتى أسندت مهمة إدارتها بالعزيز الدكتور"عبد الستار جبر الاسدي" الذي سعى جاهداً لإعادة الوجه الجميل للأقلام، وان اختلفنا مع ذلك الوجه سياسياً وفكرياً. وأول خطوات مديرها الجديد كانت بان سعى لاختيار من يكتب وينشر في المجلة، وهي اختيارات بنيت، بمجملها، على الكفاءة والتخصص المعرفي، ثم الاختيار الجيد لمحاور المجلة، بل إن عهد "الاسدي" شهد انفتاحاً عربياً على المجلة على الرغم من ظروفها السيئة من حيث التمويل والتوزيع شانها في هذا الأمر شان كل ما يصدر عن دار الشؤون الثقافية. وأخذنا نقرأ دراسات مثيرة لباحثين أجانب مكرسين، اذكر منهم إريك دافيس الذي نشرت له المجلة بحوث عدة، وهي بحوث أرسلت بصورة شخصية من الباحث نفسه، ولم تؤخذ من الشبكة العالمية للمعلومات، أو من إحدى كتبه غير المترجمة. وكان من الممكن أن تذهب الأقلام بعيداً فيما لو توفرت إدارة جيدة لدار الشؤون نفسها المسؤولة عن إصدار الأقلام وغيرها من المجلات العراقية المعروفة. وفي المحصلة، فان هناك إشادة ملحوظة من وسط ثقافي تطحنه المزاجية المفرطة والشللية بجهود صديقنا العزيز الدكتور "الاسدي"، وبإمكاني القول إنه قد أعاد الأقلام إلى سابق عهدها. وقد أقول إن تاريخ البلاد الثقافي القريب سيقول عن سنوات إدارته إنه قد فعل للأقلام ما لم يفعله كثيرون في ظروف بالغة السوء. فتحية له؛ لصمته، أولاً، أمام النص الجيد دون اعتبار لاسم كاتبه.
وشكراً؛ ثانياً وليس أخيراً لروحه وثقافته التي سمحت له أن يسمع ويرى ذاتاً تكتب وتحكي وتتذكر، أن يفهم نوازع تلك الذات المتمردة على مؤسسات فاشلة؛ فان تعمل في مؤسسة تدرك حجم فشلها وتنتج شيئاً فانها معجزة تستحق أن تكتب بماء الذهب العزيز على جدران مدينتا المرعوبة صباحاً ومساءً. وشكراً؛ لأنه فهم مبكراً أن الثقافة شان المشتغلين بها، وهي أمر ذاتي لا دخل للمؤسسات به؛ فبعد قرن كامل من تاريخ بلادنا يدرك الجميع الآن أن لا مؤسسة تستطيع، مهما علا شانها، أن تصنع مثقفاً، إنها تستطيع ان تصنع داعية يتقلب به الزمان، لكنها لن تستطيع مطلقاً ان تصنع مثقفاً، صناعة المثقف كذبة الجميع: شيوعيين وبعثيين وإسلاميين الآن: لا أحد يصنع الثقافة سوى من يحتاج إليها، وهي الذات المتمردة، الخائفة حتما من مصير مجهول يتربص بها.
*نص محاضرة الكاتب في ندوة قسم اللغة العربية بكلية التربية للبنات – جامعة بغداد يوم الاربعاء، 21،1،2015
![[\"?????? \"????]](https://kms.jadaliyya.com/Images/357x383xo/4241315246_ccc3bf1d0e_z.jpg)
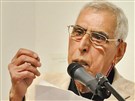



.jpg)